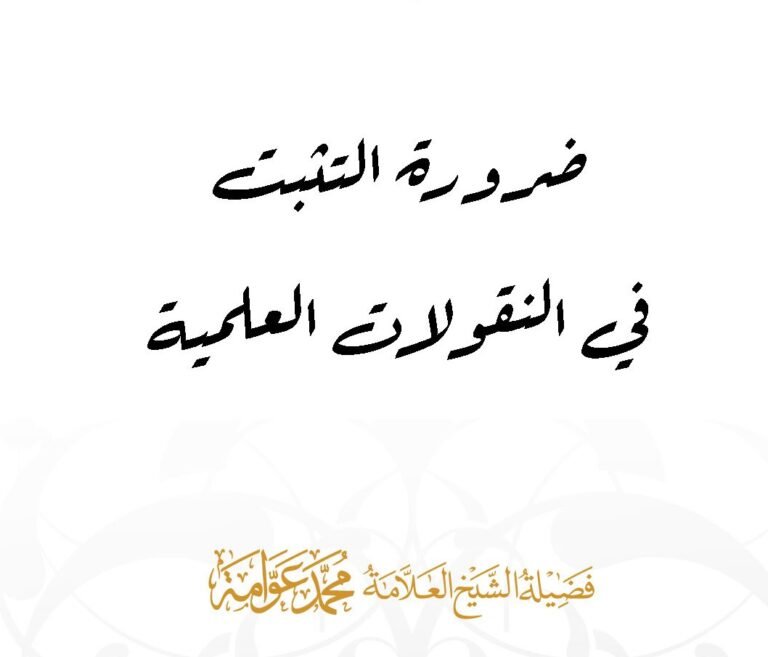بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، كما يحب ويرضى، وصلوات الله وتسليماته على صفوة خلقه من أنبيائه ورسله، وعلى سيدهم وخاتمهم، سيد السادات، محمد بن عبد الله، وعلى آل كلٍّ وصحبه، والتابعين بإحسان إلى يوم الدين.
قال شيخنا العلامة المحقق الشيخ محمد عوامة حفظه الله بلطف وعافية في مقدمة السلسلة التي أخرجها بعنوان «أبحاثٌ حديثيَّةٌ هادفةٌ لتصحيحِ المسارِ العلميِّ»:
هذه سلسلة حديثية، أفردتُ فيها جملة من مسائل علوم الحديث المهمة، أرجو الله تعالى التوفيق فيها لتصحيح مسارها الشائع بين جمهرة من الباحثين المعاصرين.
ومن مظاهر التصحيح الذي أقصده:
1ـ التنبيه إلى ضرورة اليقظة في النقل والتعامل مع المصادر القديمة والحديثة.
2ـ تحرير نقطة الخلاف والبحث ـ كما يقولون ـ.
3ـ وتحرير نسبة القول لقائله.
4ـ وتصحيح النظرة إلى كل كتاب من كتب السنة النبوية.
5ـ ثم تصحيح طريقة التعامل مع ذاك الكتاب.
6ـ ومنهجية تخريج الحديث من مصادره.
7ـ وغير هذه الأمور المنهجية التي يفتقر إليها عدد كبير من طلبة العلم، ويجمع بينها كلِّها: التأكيد على التزام منهج أئمتنا العلمي، ومحاولة الفهم عنهم فيما يكتبون، والتزام التأني في البحث والمدارسة.
وهذه المسائل كلها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بما علّقته على «تدريب الراوي»، وكنت كتبت هناك ما يسعف المقام، وأرجأت المزيد من البحث إلى هذه الرسائل المفردة.
ثم قال حفظه الله ورعاه في بحثه الأول «التَّحذيرُ من التَّواردِ على قولِ دونَ الرُّجوع إلى مصادرِه»:
إنَّ من أهم مهمات طالب العلم، الباحث عما يطمئن إليه قلبه، هو اليقظة والتحرِّي في نقوله، وإنْ لقيَ في الوصول إلى الحقيقة عنتًا ومشقة.
ومن عقبات الوصول إلى الحقيقة أمران:
أولهما: توارد الخالف على قول يقوله السالف، دون رجوع بنفسه للتحقق من صحة هذا النقل، وتفهّمه وتدبّره.
ثانيهما: الحذر من تحريف في النقل، إما في النقول القديمة (في المخطوطات)، وإما في النقول المتأخرة (في المطبوعات).
وكلاهما ليس بالأمر السهل، لكني أركّز على تحريفات حصلت لبعض الأئمة القدامى، لاطمئنان قلب الباحث إلى نقول المتقدمين، أكثر من اطمئنانه وتأثره بالنقول من المطبوعات.
وقد أفردت للأمر الأول هذا المبحث بهذا العنوان، كما أفردت للأمر الثاني المبحث اللاحق بعنوان: «كلمةٌ في التَّوقِّي من التَّحريفِ».
وأرجو الله تعالى أن يجعل هذين المبحثين ـ على وَجَازتهما ـ مَعْلَمًا نيِّرًا يستضيء به الطالب المسترشد في أبحاثه العلمية كلها. وهو وليّ التوفيق.
ثم قال في آخر فقرة من فقرات البحث الأول:
ومما يتصل بالتحذير من التوارد الذي أدعو إليه: ضرورة التثبت من النقول التي يقف عليها طالب العلم في كلام أئمتنا رضي الله عنهم، سواء أكان النقل تخريجَ حديث، أم عزوَ قول في جرح أو تعديل، أم إحالةَ نقلٍ عن قائل، إذا كان هذا التثبت في وسعي.
ومنذ أكثر من أربعين سنة كنت أقول لإخواني الطلبة في بلدي الأول: حلب: لو قال قائل: إن الحافظ ابن حجر هو أعرف بما في «صحيح» البخاري من الإمام البخاري نفسه لما كان مجازفًا، ومع ذلك:
1 ـ فقد روى البخاري في «صحيحه»(1) من طريق ابن المبارك، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: «إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربَّنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟..».
ولما شرحه الحافظ قال رحمه الله(2): «قوله «وسعديك»: زاد سعيد بن داود، وعبد العزيز بن يحيى كلاهما عن مالك، عند الدارقطني في «الغرائب»: والخيرُ في يديك».
وهذا من عَجَب العَجَب، ذلك أن هذه الزيادة هي عند البخاري نفسه(3) من رواية عبد الله بن وهب، عن مالك!
ومثال آخر نحو هذا.
2 ـ عرض الحافظ رحمه الله في «الدراية»(4) لحديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه في صفة وضوء النبي ﷺ، فقال: «وأخرج البخاري من رواية فليح ـ بن سليمان ـ، عن عمرو بن يحيى، بسنده في هذا الحديث: أن النبي ﷺ توضأ مرتين مرتين».
وأقول: إن البخاري روى هذا الحديث عن فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وليس عن عمرو بن يحيى كما سبق إليه ذهن الحافظ(5)، وقد روى البخاري حديث عبد الله بن زيد الأنصاري المطوَّل في صفة الوضوء عن عمرو بن يحيى في ستة مواضع(6)، وليس في واحد منها ذكر رواية فليح له عن عمرو، ولم يذكر المزي ذلك في «تحفة الأشراف»(7)، بل لم يذكر المزي في «تهذيب الكمال» فليحًا في ترجمة عمرو، ولا عَمرًا في ترجمة فليح(8).
فنسبة الحافظ ابن حجر هذه الصورة الإسنادية ـ فليح، عن عمرو ـ إلى البخاري: من أغرب ما وقع له رحمه الله تعالى، وهو مَن هو في خِدَماته لـ «صحيح» البخاري!!
وبمناسبة الاستدراك في العزو أقول: إن التوارد في عزو إمام حديثًا إلى مصدر: أمر معهود في واقع علمائنا المتأخرين، وقد وقفت على أمثلة غير قليلة وأنا في خدمة «نصب الراية» والكتب الأخرى التي معه، ومنها الدراية..
وأختار منها هذا المثال من أجل توقف العلامة البنوري الذي يراه القارئ الكريم في «معارف السنن»(9).
ذكر الزيلعي في «نصب الراية»(10)، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعًا: «صلِّ قائمًا ..»، وقال في تخريجه: «أخرجه الجماعة إلا مسلمًا، وزاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيًا: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. انتهى».
وأنقل هنا ما علقته عليه هناك بعد ما خرجته من البخاري والسنن إلا النسائي:
أما النسائي: فالحديث ليس فيه بهذه الصياغة، ولا بهذه الزيادة، إنما روى النسائي حديثًا واحدًا لعمران بن حصين(11): «من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا ـ أي: مضطجعًا ـ فله نصف أجر القاعد». هنا الحديث بهذا اللفظ.
وكأن مبدأ نسبة هذه الزيادة إلى النسائي من ابن قدامة (ت620) في «المغني»، ومن عصريّه مجد الدين ابن تيمية (ت652) في «منتقى الأخبار» بشرحه «نيل الأوطار»، وتبعهما القرشي في «العناية»، والمصنف ـ الزيلعي ـ هنا، وابن الملقن في كتابيه «البدر المنير»، و«تحفة المحتاج»، وابن حجر في كتابيه «التلخيص الحبير»، و«الدراية». كما تبع المصنفَ: ابن الهمام في «فتح القدير»، والعيني في «البناية»(12).
وكل هذا من التوارد الذي أَحذَرُه، وأحذِّر منه، وكتبت فيه بحثًا خاصًّا طبعته بعنوان «التحذير من التوارد على قول دون الرجوع إلى مصادره»، وأسأل الله التوفيق. انتهى ما علقته، وهو مثال كافٍ للاعتبار، ولا أبرئ نفسي من الوقوع فيما أحذره، وأحذر منه، وأستغفر الله العظيم من كل خطأ وخطيئة.
3ـ ذكر الحافظ رحمه الله في «الدراية»(13) طرفًا من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي ﷺ: «لا يُصَوِّب رأسه ولا يُقْنعه»، وعزاه إلى البخاري، تبعًا للزيلعي في «نصب الراية»(14)، والواقع أنه ليس فيه هذا اللفظ، نعم، لأبي حميد حديث في البخاري(15)، لكن ليس فيه هذا. والله أعلم.
4 ـ وأعجب من هذا! نُقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قولُه: «ما بَعَث الله نبيًّا قطُّ إلا أَخذ عليه العهد لئن بُعث محمد ﷺ وهو حيّ ليؤمنن به ولينصرنَّه..».
وقد عزا رواية هذا القولِ إلى البخاري: ابن كثير في «تاريخه»(16) ـ أو «السيرة النبوية» المفردة منه ـ، والزركشي في «شرح البردة»(17)، والحافظ في «الفتح»(18)! فهؤلاء ثلاثة حفاظ، وثلاثتهم من شراح البخاري، وتواردوا على عزو هذا القول إلى البخاري، وليس فيه.
والفضل في التنبيه إلى هذه الفائدة يعود إلى الحافظ الإمام الموسوعي الصالحي رحمه الله تعالى في سيرته «سُبُل الهدى والرشاد»(19)، ونقلها عنه الإمام الزرقاني في «شرح المواهب»(20).
فلا بدّ من مراجعة الأصول والتثبت مما يُعزى إليها، وإلا فمن يقوى على مخالفة ابن حجر فيما ينسبه إلى «صحيح» البخاري؟! فكيف ومعه إمامان آخران حافظان ذوا صلة وثيقة بالصحيح أيضًا؟!
5 ـ قال البخاري في «صحيحه»(21): «وقال ابن وهب: أخبرني يونس..»، فقال الحافظ: «سيأتي للمصنِّف موصولًا من وجه آخر عن ابن وهب..» (22).
قلت: نعم سيأتي موصولًا عنده(23)، لكن من غير طريق ابن وهب أبدًا، ولم يعرض لهذا في «تغليق التعليق»، ولا في «مقدمة الفتح»(24).
6 ـ وتنبيه أخير. قال ابن كثير رحمه الله في آخر سطر من مقدمة «تفسيره»(25) قبل البدء بتفسير سورة الفاتحة: «قال أبو عمرو الداني: لا أعلم كلمة هي وحدَها آية إلا قوله: {مُدْهَامَّتَانِ}، في سورة الرحمن»، فرأيت أن هذا عَجَب يماثل العجبَ مما قدّمته عن الحافظ ابن حجر مع «صحيح البخاري»، بل هو أشدّ، فإمامة أبي عمرو الداني فيما يتصل بالقرآن العظيم لا تقلّ عن إمامة ابن حجر فيما يتصل بكتاب البخاري! وأين هو من الآية الأولى من السورة نفسها: {الرَّحْمَنُ}!، فضلًا عن قوله تعالى: {الْحَاقَّةُ}، {الْقَارِعَةُ}، يضاف إليها الكلمات التي معها واو القسم: {وَالْفَجْرِ}، {وَالضُّحَى}، {وَالْعَصْرِ}.
فسألت الأخ الكريم المقرئ المتقن فضيلة الشيخ محمد تميم الزُّعْبي حفظه الله تعالى: هل للإمام الداني كتاب في عدّ آي القرآن الكريم؟ فقال: نعم، له كتاب «البيان في عدّ آي القرآن»، فذكرت له كلام ابن كثير، فأجابني بعد قليل: إنه نظر في كتاب الإمام الداني، فرآه في ص126 قد عَرَض لما نقله عنه ابن كثير، وفيه ذِكر ما جاء في فواتح السوَر مما هو كلمة واحدة، ثم قال: «فأما في حَشْوهنّ ـ أي: أثناء السور ـ فلا أعلم كلمة هي وحدَها آية في ذلك إلا قوله تعالى: {مُدْهَامَّتَانِ} لا غير»، فأفاد أن نفيه مقيَّد بما هو أثناء السور لا في فواتحها، وليس في كلام ابن كثير هذا القيد، فعرَّض الإمامَ الدانيَّ للمؤاخذة.
ومثل ما في كلام ابن كثير من المؤاخذة، ما جاء في كلام القرطبي في أول «تفسيره»(26)، وكأن ابن كثير أخذ كلام القرطبي، فراجعِ النقول دائمًا من مواردها، والله هو المستعان، وهو الموفق(27).
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين(28).
(1) (6549).
(2) >الفتح< 11: 422.
(3) تحت رقم (7518).
(4) تحت رقم (110).
(5) تحت رقم (158).
(6) تحت الأرقام التالية (185، 186، 191، 192، 197، 199).
(7) (5308).
(8) نعم له رواية واحدة عند أبي يعلى في >مسنده< (1071).
(9) 3: 451.
(10) 2: 175 من الطبعة القديمة، (1946) بترقيمي.
(11) (1366) في >الكبرى<، وهو في >الصغرى< (1660).
(12) >المغني< 1: 777، و>منتقى الأخبار< 3: 242، و>العناية< (498)، و>البدر المنير< 7: 317، و>تحفة المحتاج< 1: 287، و>التلخيص الحبير< 2: 636، و>فتح القدير< 1: 457، و>البناية< 3: 193.
(13) 1: 239.
(14) 1: 375 (1206) بترقيمي.
(15) (828).
(16) >البداية< 3: 496، أو >السيرة< 1: 287.
(17) صفحة 161 ولفظه: >روى البخاري في الصحيح<.
(18) 6: 434 في شرح الباب 27 من كتاب أحاديث الأنبياء.
(19) 1: 109.
(20) 1: 40.
(21) (3434).
(22) >فتح الباري< 6: 473.
(23) برقم (5082، 5365).
(24) >تغليق التعليق< 4: 35، و>المقدمة< ص49.
(25) 1: 128.
(26) 1: 67.
(27) ومما يتصل بالتوارد وقد درج عليه الكثيرون: إهمال توثيق ابن حبان: وكنت أرى اعتماد توثيقه إذا لم يُقابَل بجرحٍ من قِبَل غيره، أما إذا جُرح من قِبَل غيره بنصّ صريح في الجرح: فلا، فإن كان الجرح
الجهالة، بأنْ ذكره ابن حبان في >الثقات<، وقال فيه أبو حاتم وغيره: مجهول، فلا أعتدّ بهذه الجهالة، بل أقدَّم عليها قول ابن حبان.
وقد أفردت هذا المبحث بالكتابة، وطبعته في مقدمة >مصنف< ابن أبي شيبة. ثم مع >دراسات الكاشف< للإمام الذهبي، ثم أفردته بالطباعة مع زيادات عليه بعنوان: >لمحات في بيان مذهب ابن حبان في عرفة الثقات<. ورأيت إفراده بالطبع ضمن هذه السلسلة، فطبعته، والحمد لله.
(28) انتهى كلام شيخنا حفظه الله ورعاه، ينظر ص 5 ـ 8، 23 ـ 27.
 مرئيات
مرئيات الكتب
الكتب أبحاث مستخلصة
أبحاث مستخلصة صوتيات
صوتيات المؤتمر
المؤتمر